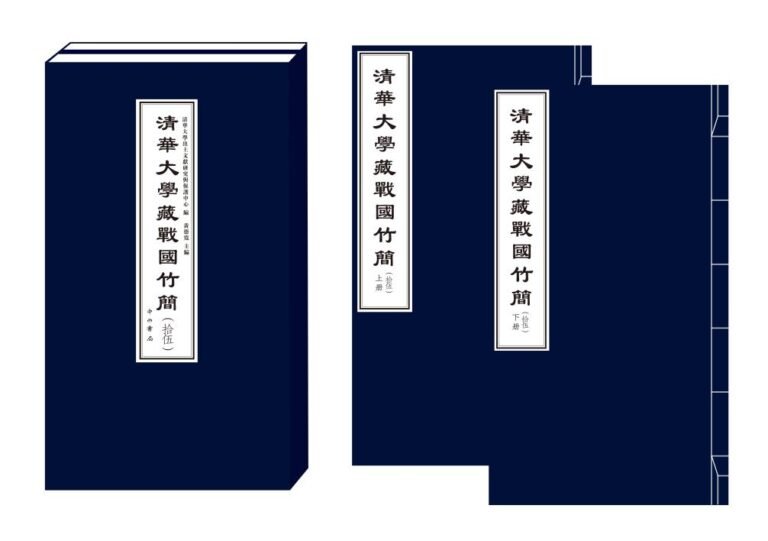شؤون آسيوية – إعداد: رغد خضور –
لم يكن الشرق الأوسط يومًا مجرد بقعة جغرافية على الخريطة السياسية للعالم، بل كان ولا يزال مركزاً لتقاطعات تاريخية معقدة جعلته جزءاً من معادلة القوى الكبرى، فمنذ مطلع القرن العشرين ارتبطت المنطقة باكتشافات النفط وبروزها كمخزون استراتيجي للطاقة، وبموقعها الذي يربط ثلاث قارات عبر الممرات البحرية الكبرى مثل قناة السويس ومضيق هرمز وباب المندب.
هذه الجغرافيا المميزة، الممزوجة بتركيبة سكانية ودينية متشابكة، جعلت الشرق الأوسط دائمًا ساحة لا يمكن الاستغناء عنها في حسابات القوى العظمى، إذا كانت الولايات المتحدة قد انفردت لعقود بقبضة شبه مطلقة على مفاتيح المنطقة، فإن العقدين الأخيرين حملا تغييرات متسارعة.
فمن جهة، تراجع وزن الشرق الأوسط في الاستراتيجية الأمريكية بفعل “إرهاق الحروب” وصعود النفط الصخري في الداخل الأمريكي. ومن جهة أخرى، برزت الصين كقوة اقتصادية طموحة تريد تأمين مستقبلها من خلال توسيع نطاق حضورها في العالم. والنتيجة أن المنطقة عادت لتكون محور لعبة كبرى جديدة، لكنها هذه المرة ليست مواجهة أيديولوجية تقليدية كما كان الحال بين واشنطن وموسكو، بل صراع على النفوذ يتداخل فيه الاقتصاد مع الأمن والدبلوماسية الناعمة.
بين الهيمنة الأمريكية والتراجع
منذ الحرب العالمية الثانية، بنت الولايات المتحدة استراتيجيتها في الشرق الأوسط على ثلاثة أعمدة رئيسية: ضمان تدفق النفط بأسعار معقولة، منع تمدد خصومها الجيوسياسيين، وحماية إسرائيل كحليف استراتيجي.
خلال الحرب الباردة، مثّل الإقليم ساحة مواجهة غير مباشرة مع الاتحاد السوفيتي، عبر تحالفات أمنية مع أنظمة المنطقة: من “الحلف المركزي” الذي ضم تركيا وإيران وباكستان، إلى علاقاتها الوثيقة مع السعودية ودول الخليج، والتدخلات الأمريكية لم تكن مجرد دعم سياسي أو اقتصادي، بل اتخذت شكلًا عسكرياً مباشراً في أحيان كثيرة: من إنزال مشاة البحرية في بيروت عام 1958 إلى حرب الخليج الأولى عام 1991.
وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي بدت الساحة خالية أمام الولايات المتحدة لتعزيز هيمنتها، وبدل أن تكرّس أمريكا تفوقها عبر استراتيجية رشيدة، تورطت في حروب استنزاف كبرى، كغزو العراق عام 2003 الذي أطاح بنظام صدام حسين الذي فتح الباب أمام فوضى إقليمية، وحرب أفغانستان التي تحولت إلى أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة. هذه الحروب كلّفت الخزينة الأمريكية تريليونات الدولارات، وأثرت سلبًا على صورة واشنطن عالميًا، إذ بدت كقوة غازية أكثر من كونها شريكًا للتنمية والاستقرار.
خلال العقد الماضي، بدأت واشنطن تعيد التفكير في جدوى هذا الحضور المكثف، وهناء أدى اكتشاف النفط والغاز الصخري إل تقليل اعتمادها على نفط الخليج، ما غذّى اتجاهًا داخل واشنطن نحو تقليص الانخراط المباشر في المنطقة.
في الوقت نفسه، دفع صعود الصين في آسيا إلى نقل مركز اهتمامها نحو منطقة “المحيطين الهندي والهادئ”، غير أن الواقع أظهر أن الانسحاب الكامل غير ممكن، خاصة بعد تدخل روسيا في سوريا عام 2015، وتنامي النفوذ الإيراني في العراق واليمن ولبنان، وظهور فاعلين إقليميين جدد مثل تركيا، كلها عوامل أجبرت الولايات المتحدة على البقاء، ولو بوزن أقل، ووسط كل ذلك، ظهر منافس جديد، الصين، التي لم تأتِ بدبابات أو حاملات طائرات، بل بحقائب استثمارية ومبادرات اقتصادية تحمل بريق التنمية.
الصين.. من لاعب اقتصادي إلى منافس استراتيجي
عرفت العلاقة الصينية بالشرق الأوسط تحولات تدريجية، ففي الحقبة الماوية، كانت بكين تدعم حركات التحرر الوطني من موقع أيديولوجي، لكنها لم تكن تملك الأدوات الاقتصادية أو العسكرية للانخراط العميق، ومع إصلاحات دنغ شياوبنغ في أواخر السبعينات، تحولت الأولوية إلى التنمية الداخلية، فاقتصرت علاقة الصين بالمنطقة على شراء النفط وتصدير بعض السلع البسيطة.
لكن بداية القرن الحادي والعشرين شهدت تغيراً نوعياً، إذ نما الاقتصاد الصيني بوتيرة هائلة، ما جعل تأمين مصادر الطاقة الخارجية قضية أمن قومي، ما جعل المنطقة ساحة جديدة للتنافس الاستراتيجي.
الشرق الأوسط برز كحليف لا غنى عنه، خاصة مع إطلاق مبادرة “الحزام والطريق” عام 2013، حيث أصبحت المنطقة محطة مركزية في مشروع يربط الصين بأوروبا وأفريقيا عبر استثمارات في البنية التحتية والموانئ والسكك الحديدية، وصارت الموانئ في الدقم بسلطنة عمان، وحيفا في إسرائيل، وبورسعيد في مصر، ومشاريع في السعودية والإمارات، نقاط ارتكاز في هذه الشبكة.
في البداية ركزت بكين على الاقتصاد وحده، متجنبة أي تورط سياسي أو أمني قد يثير حفيظة واشنطن، لكن مع مرور الوقت، اكتشفت أن حماية مصالحها الاقتصادية يتطلب حضوراً أمنياً أيضاً، وعليه بدأت الصين ترسم لنفسها صورة قوة مسؤولة، تجلى ذلك في نقاط عدة منها إرسال أسطول لمكافحة القرصنة إلى خليج عدن عام 2008 مثّل أول خروج بحري صيني بعيد المدى، ولاحقًا، جاء إنشاء قاعدة عسكرية في جيبوتي عام 2017 كدليل على أن الصين لم تعد تكتفي بالرمزية، بل تريد موطئ قدم دائمًا في محيط المنطقة، إلى جانب مناورات مشتركة مع إيران والسعودية ومصر، غير أن هذه الخطوات ظلت متواضعة مقارنةً بالانتشار الأمريكي، لكنها تحمل رمزية استراتيجية.
أمن الطاقة.. قلب التنافس
الطاقة هي المفصل الذي تتقاطع عنده مصالح بكين وواشنطن، بالنسبة للصين، استقرار تدفق النفط والغاز من الشرق الأوسط هو شرط لبقاء اقتصادها متماسكاً، إذ إن أكثر من نصف وارداتها من النفط تأتي من دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية والعراق والإمارات، إضافة إلى أن إيران، ما يعني أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو باب المندب قد يشل جزءاً كبيراً من اقتصادها.
الولايات المتحدة، في المقابل، لم تعد تعتمد على نفط المنطقة بالقدر نفسه، لكنها تدرك أن سيطرتها على طرق الشحن وأنظمة التمويل يمنحها أداة ضغط غير مباشرة على بكين، لهذا تخشى الصين من أن تستخدم واشنطن هذه الورقة في أي مواجهة مستقبلية.
وتمثل محاولة الصين كسر احتكار الدولار في تجارة النفط عبر “اليوان النفطي” بعداً آخر للتنافس، حيث إنه من صحيح أن الدولار لا يزال يهيمن على أكثر من 60% من الاحتياطيات العالمية، مقابل أقل من 3% لليوان، لكن مجرد قبول بعض الدول الخليجية بصفقات باليوان يعني بداية تشققات في النظام المالي الدولي الذي أسسته واشنطن بعد الحرب العالمية الثانية، وهذا بالنسبة لأمريكا ليس مسألة اقتصادية وحسب بل يرتبط بقدرتها على التحكم في شرايين الاقتصاد العالمي.
الحضور الأمني والعسكري الصيني
رغم أن بكين لا تطرح نفسها كبديل عسكري شامل ولا تملك شبكة قواعد ولا تحالفات عسكرية واسعة كالولايات المتحدة، إلا أنها تتقدم خطوة بخطوة، حيث تؤمن لها القاعدة في جيبوتي إشرافًا على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، كما أن استثماراتها في موانئ مثل “الدقم” العُماني و”بورسعيد” المصري و”حيفا” الإسرائيلي تمنحها أوراق قوة لوجستية يمكن أن تُستخدم مستقبلًا لأغراض مزدوجة، وهذا ما يُعرف بـ”الاندماج العسكري–المدني”، حيث تُستخدم المؤسسات التجارية الخاضعة للدولة لدعم الأصول العسكرية.
الأكثر إثارة للانتباه هو توسع الصين في سوق السلاح الإقليمي، حين امتنعت واشنطن عن بيع طائرات مسيّرة هجومية متطورة لدول عربية لأسباب تتعلق بميزان القوى مع إسرائيل، وجدت هذه الدول ضالتها في بكين، إذ حصلت كل من السعودية والإمارات ومصر والمغرب على مسيّرات صينية أثبتت كفاءتها في النزاعات، كذلك لجأ الأردن هو الآخر إلى الصين بعد أن رفضت أمريكا طلبه. هذه الصفقات ليست مجرد تجارة، بل تعني خلق اعتماد طويل الأمد على التكنولوجيا الصينية وصيانتها.
الانسحاب أم المواجهة؟
داخل الولايات المتحدة لا يوجد إجماع حول كيفية التعامل مع الشرق الأوسط في ظل صعود الصين، بل يوجد ثلاث رؤى متعارضة تجاه المنطقة.
أحد هذه التيارات يعتبر الشرق الأوسط “الحدود الجديدة” لصراع النفوذ مع الصين، ويطالب بإعادة الاستثمار العسكري والسياسي لمنع بكين من ملء الفراغ وتعزيز الوجود العسكري والدبلوماسي.
التيار الثاني يعتبر أن المنطقة استنزفت واشنطن لعقود، إذ تراجعت أهميتها بعد استقلال أمريكا في مجال الطاقة، والأفضل – وفقاً لهم – هو التركيز على آسيا وترك الشرق الأوسط للصينيين، طالما أن النفط لم يعد مسألة حياة أو موت لأمريكا.
والاتجاه الثالث – وهو الأكثر واقعية – فإنه يدعو إلى توازن دقيق، لجهة تقليص الكلفة دون السماح بفراغ استراتيجي، مع مراقبة النفوذ الصيني عن قرب، خوفًا من سوء تقدير قد يقود إلى مواجهة غير مقصودة.
هذا الانقسام يعكس معضلة عميقة، وهي أن الولايات المتحدة تريد التركيز على منافستها الكبرى في آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ لاحتواء الصين، لكنها تجد نفسها مضطرة للبقاء في الشرق الأوسط خوفاً من أن يتحول إلى “خاصرة رخوة” تستغلها بكين أو موسكو.
المقاربات الدبلوماسية..
التباين بين واشنطن وبكين يظهر بوضوح في إدارة ملفات الصراع، إذ لا يقتصر على الاقتصاد والأمن، بل يمتد إلى قراءة جذور أزمات المنطقة.
أمريكا تميل إلى معالجة النتائج، كوقف هجمات الحوثيين، ومنع إيران من تخصيب اليورانيوم، إلى جانب حماية أمن إسرائيل، فيما تركز الصين، بالمقابل، على الأسباب الجذرية كتسوية القضية الفلسطينية، تقليص التوترات بين القوى الإقليمية، دعم التنمية الاقتصادية كطريق للاستقرار.
في العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2023، طالبت الصين بوقف فوري لإطلاق النار داخل مجلس الأمن، وانتقدت الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل. حتى أنها استضافت لقاءات بين الفصائل الفلسطينية لتقريب وجهات النظر، في حين، كان التركيز الأمريكي على حماية إسرائيل، حيث طلبت واشنطن من بكين استخدام نفوذها على طهران للضغط على حلفائها.
مع ذلك، ليست كل الملفات متناقضة، ففي الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، عملت الصين والولايات المتحدة معًا ضمن مجموعة (5+1)، لكن حين انسحب ترامب من الاتفاق عام 2018، رفضت بكين السير خلف واشنطن، معتبرة أن سياستها تفتقر إلى المنطق.
هذا الاختلاف يعكس فلسفتين متناقضتين: واحدة ترى الأمن أولاً، وأخرى ترى العدالة شرطاً للأمن.
مكاسب دول المنطقة..
دول الشرق الأوسط لا تنظر للتنافس باعتباره مأساة، بل فرصة لتعظيم المكاسب، فالدول العربية والإقليمية لم تعد أسيرة اصطفافات الحرب الباردة، إذ تحاول الاستفادة من التنافس لصالحها.
ودول الخليج مثال حي، فمن جهة تحصل على ضمانات أمنية وأسلحة متطورة من واشنطن، وفي الوقت ذاته تجذب استثمارات صينية في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، وعلى سبيل المثال، أعلنت السعودية استعدادها لبيع جزء من نفطها باليوان، من دون أن تقطع شراكتها التاريخية مع الولايات المتحدة.
الإمارات أيضاً تعتبر الحليف التجاري الأول لواشنطن في المنطقة، وفي الوقت نفسه تعد من أهم شركاء الصين في مشاريع الموانئ والطاقة، هذا بالإضافة إلى مصر والمغرب اللتان تبحثان عن شركاء متنوعين، بين سلاح أمريكي واستثمارات صينية.
حتى إسرائيل، رغم ضغوط واشنطن، كانت متحمسة للاستثمارات الصينية في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية، قبل أن تضطر لتقليصها، بفعل الضغوط الأمريكية.
هذا السلوك يعكس إدراكاً متزايداً من دول المنطقة بأن زمن الاعتماد على قوة عظمى واحدة قد انتهى، وأن المصلحة الوطنية تكمن في تنويع الشراكات.
إلى أين يتجه التنافس؟
المشهد الحالي يوحي بأن الشرق الأوسط لن يشهد مواجهة عسكرية مباشرة بين واشنطن وبكين في المستقبل القريب.
حتى الآن، لا يبدو أن الصين تسعى إلى تحدٍ مباشر للوجود الأمريكي، فهي تفتقر إلى القدرات العسكرية الكفيلة بمنافسة واشنطن إقليمياً، لكنها تراهن على الزمن والتراكمات البطيئة، استثمارات، صفقات سلاح، حضور دبلوماسي متزايد.
الولايات المتحدة من جانبها لا تستطيع التخلي عن المنطقة، لأن ذلك يعني خسارة ورقة استراتيجية في قيادة النظام العالمي. لكنها تجد نفسها مضطرة إلى توزيع مواردها بين آسيا والشرق الأوسط، ما يضعف قدرتها على الحسم.
التنافس بين الطرفين قد يأخذ شكل “تعايش اضطراري”، باعتبار واشنطن الحامي الأمني، وبكين شريك اقتصادي، لكن هذا التوازن الهش يجعل أي خطأ في الحسابات عرضة لأن يشعل مواجهة غير مقصودة، سواء حول الممرات البحرية أو في سباق التكنولوجيا.
تحول في بينة النظام العالمي..
الصراع الأمريكي–الصيني في الشرق الأوسط ليس مجرد فصل جديد من التنافس الدولي، بل هو انعكاس لتحول أوسع في بنية النظام العالمي. المنطقة التي عانت طويلاً من كونها “ساحة” للقوى العظمى، تجد نفسها اليوم في قلب معركة بين قوة مهيمنة تحاول الحفاظ على موقعها، وقوة صاعدة تريد إعادة رسم قواعد اللعبة.
الولايات المتحدة تنظر إلى استمرار نفوذها في الشرق الأوسط كجزء من شرط قيادتها للعالم. الصين ترى في الحضور الاقتصادي والسياسي في المنطقة نقطة ارتكاز لمشروعها الكوني. أما دول الشرق الأوسط، فهي تحاول تحويل هذه المنافسة إلى فرصة لتحقيق استقلالية أكبر ومكانة دولية أوسع.
لكن إن فشل الطرفان الكبيران في إدارة خلافاتهما بعقلانية، فقد تتحول المنطقة إلى بؤرة صراع عالمي تتجاوز حدودها الجغرافية، لتطال أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى. وهذا ما يجعل الشرق الأوسط مرة أخرى، وربما دائمًا، مركزًا للعالم أكثر مما يرغب سكانه أنفسهم.