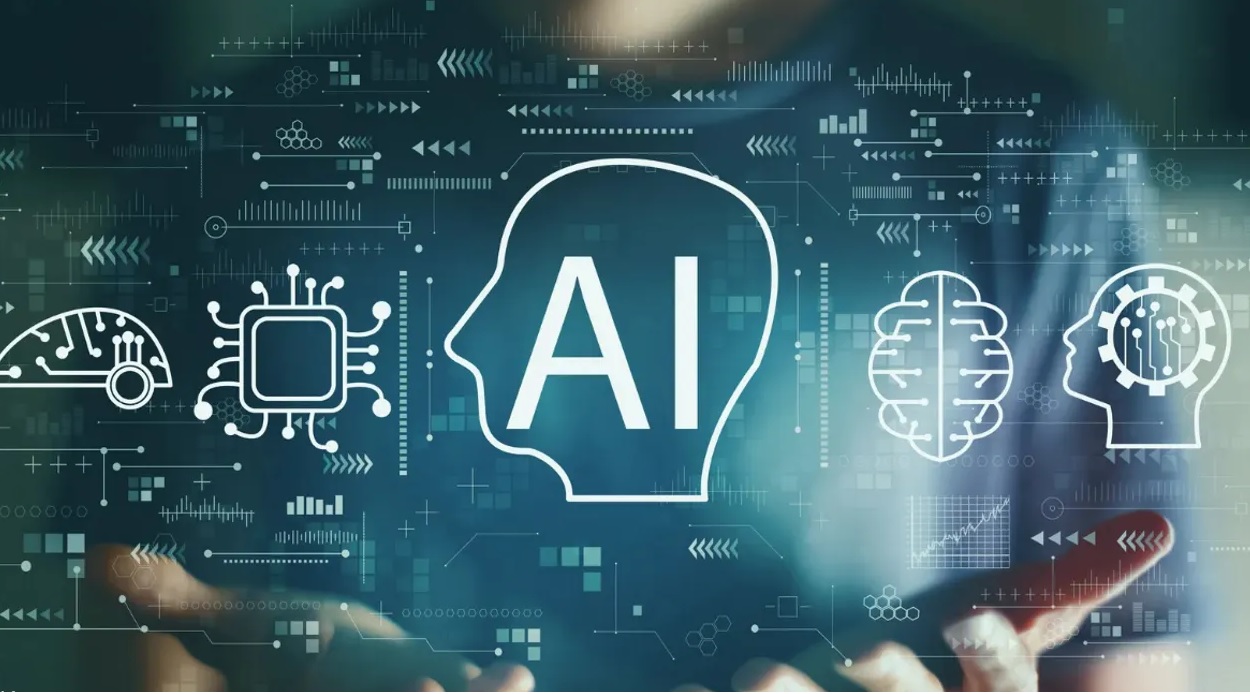
الذكاء الإصطناعي:
تعريفه، تاريخه، مكاسبه ومثالبه.
خاص شؤون آسيوية – بقلم كارمن جرجي*/
تقدّم ُتكنولوجي وأداة طوّرها الإنسان بغية خدمته ولإضافة مكسب حضاري يساهم في نهضته، إلّا أنّ هذه الثورة أصبحت عبئاً أخلاقياً يُشكِّل تهديداً وجودياً. بين الأمل والمخاوف، هل قدّم العلماء للعالم منحة أم محنة؟
بدأت أولى مراحل الثورة الرقمية منذ عام ۱۹۵۰، مع طروحات آلان تورينغ، العالم البريطاني الذي يعتبر الأب الروحي والمؤسس لفكرة الذكاء الإصطناعي:
Artificial Intelligence.
تورينغ لم يخترعه الّا أن أفكاره كانت الأساس لهذه الفلسفة، إذ طرح الإشكالية الشهيرة : ” هل تستطيع الآلة أن تفكر؟”، ولهذه الغاية وضع آختباراً عُرِف ب”إختبار تورينغ” يتمحور حول امكانية البشر رصد الإنسان وتمييزه عن آلة خلال تحدثه اليها، فإذا لم يتمكن من التمييز بين الإنسان والآلة، تعتبر الآلة ذكية واجتازت الإختبار حسب مقياس اختبار تورينغ.
عام ۱۹۵٦، أطلق عالم الحاسوب الأمريكي، جون مكارثي، مصطلح الذكاء الإصطناعي واخترع لغة البرمجة “ليسب”:
LISP
والتي أصبحت لغة الذكاء الإصطناعي إنطلاقاً من عام ۱۹٦٠ وقد لفت في خُطَبِه أن الحاسوب سيصبح تجارياً بمتناول الجميع مثل الماء والكهرباء وسيسعى العالم لإقتنائه.
في حوالي سنة ۱۹٦۵، قام أحد الطلاب في جامعة ماساتشوستس بتطوير آلة عرفت ب “إليزا” وهي تحاكي المرضى النفسيين بهدف معالجتهم، وتمكنت هذه الآلة من النجاح في اختبار تورينغ، إلا أنها لم تكن ذكية بدرجة كبيرة بالنسبة للمعايير الموجودة حالياً، وهي أيضاً محدودة ترتكز على معالجة اللغات فقط:
Language Processing.
ولغاية عام ۱۹۹۵، قام العديد من الباحثين والعلماء بتطوير العديد من الآلات الذكية، لكن النتائج لم تكن مرضية تماماً.
عام ٢٠٠٠، تطورت قدرات الحاسوب وتوفرت بيانات هائلة وبدأت خوارزميات التعلم الآلي التي تسمح للآلة أن تتعلم بدل أن تبرمج يدوياً وظهرت العديد من التطبيقات مثل البحث وتحليل النصوص والصور.
ثم استمرّ التعلُّم العميق بالتطور لغاية عام ٢٠٢٠ حيث ظهرت نماذج عديدة من الذكاء التوليدي والعام مثل ChatGPT، وهي قادرة على كتابة النصوص وابتكار الصور والبرمجة والترجمة والمحادثة. فأصبح بذلك الذكاء الإصطناعي جزءاً أساسياً في حياة الإنسان اليومية ولا يوجد تعريف موحّد له ، الّا أنه يمكن أن يُختصر بقدرة الآلة على استخدام معطيات من خلال أجهزة استشعار أو إدخال رقمي أو عن بعد، ثم تحلِّلها قبل إتخاذ القرار ثم تستجيب للمحفزات بشكل يشبه أو حتى يتفوّق على قدرة البشر على التأمل واصدار الأحكام وتكوين الرأي.
وحتى الآن ومن ضمن أنواع الذكاء الآصطناعي، تم إنجاز الآلات التفاعلية التي تتفاعل مع المواقف الحالية دون التعلُّم من الماضي، وذاكرتها محدودة تستخدم بيانات محفوظة لإتخاذ قرارات حالية، أمّا المرحلتان اللّتان لم يتم إنجازهما بعد هما:
– “نظرية العقل” حيث يكون للآلة القدرة على فهم المشاعر والنوايا والأفكار وهي قيد البحث النظري والعلمي.
– “الوعي الذاتي” وهو أعلى مستوى ذكاء آصطناعي حيث تبلغ الآلة مرحلة الإدراك أنها موجودة ومدركة لذاتها. فهل يمكن يوماً ما الوصول لهذه الدرجة من الوعي؟ وماذا سيكون مستقبل البشر عندها؟ وهل سيجمع الناس على فكرة أن الذكاء الإصطناعي هبة بشرية أم سيصبح خطراً يهددهم ويهدد وجودهم.
في الماضي، كان الحاسوب نظرية ولم يكن له أي وجود وكان مجرّد نظام نظري ولكن مع مرور السنين أصبح آلة موجودة في معظم البيوت ومكملاً للحياة العلمية والتعليمية والعملية، لذلك ليس غريباً ولا ببعيد أن يتم التوصل لإبتكار آلة مدركة لذاتها، ربما تفرض وجودها وتنافس الإنسان وربما تعتبره خطراً عليها؟! لكن هذا المفهوم وهذه الأفكار لا تزال حبيسة في خيال أصحابها والخيال العلمي، وهي أشبه بأفكارٍ في أفلام ديستوبية (أيّ الخيال المظلم).
دون الغوص في المخاطر التي تكمن في تطور الذكاء الإصطناعي بشكل عميق، الأفضل التركيز حالياً على المزايا العلمية والفنية له، إذ يمكن استخدامه في مجالات عديدة مثل الطب والرعاية الصحية (التصوير- التحليل- الجراحة…) – التعليم (صنع المحتوى – تصحيح- تقييم- تحليل والحلّ…) – الصناعة (روبوتات التصنيع وآلات متطورة…) – المواصلات – الترفيه ووسائل التواصل الإجتماعي – المجال المالي والمصرفي ، ولا يمكن إغفال أهمية استخدامه في مجال الأمن والدفاع والهجوم (طائرات ذكية التحكُّم- أنظمة المراقبة – تطوير برامج- أسلحة ومتفجرات…) هذا وشهد العالم حالياً كيف يمنح تطور هذا المجال تحديداً السيطرة لبعض الدول ومصدراً للقوة إقتصادياً وعسكرياً، ويشكِّل تهديداً على دول أخرى تفتقر لهذا الكمّ من التقدُّم، وبالتالي يكَوِّن أحد أهم الإيجابيات لبعضها وأسوء السلبيات لأخرى.هذا الى جانب مساوئ أخرى عديدة للذكاء الإصطناعي مثل التحيُّز في تأمين المعلومات الجاري البحث عنها بسبب مصدر البيانات الغير المتوازن، بالإضافة الى انتهاك الخصوصية، الأخبار الزائفة، المفبركة والمضلِّلة، كما يؤدي في بعض الأحيان الى فقدان الوظائف في بعض القطاعات التي تعتمد على اليد العاملة دون الحاجة الى الإبتكار، كما يشلّ من قدرة الإنسان على الإبتكار والإبداع، وخاصية النقد والرأي الشخصي مما يُضعِف الهوية البشرية والخصائص التي يتميَّز بها الإنسان. بالإضافة الى ما يشكله من انتهاك للحقوق المحفوظة خاصة عندما يستخدم بطريقة غير أخلاقية دون ذكر المصادر ودون نسب الفضل لأصحاب الأفكار والمعلومات.
بينما للذكاء الإصطناعي مساوئ كثيرة، خطيرة، قريبة وبعيدة لا يجب إستباقها، ورغم أنه لا يجب غضّ النظر عنها ومن الضروري التفكير بها، الّا أنه يُقدم فائدة تاريخية عظيمة إذا تمّ إدارته بحكمة. فبقدرته على ابتكار النصوص والمحتوى، الترجمة، التحليل والحلّ، يوفر الوقت ويُسرِّع في إنجاز المهمات، يساهم في تحسين بعض الخدمات وخاصة التي تتطلب من الإنسان جهداً بشرياً أكثر من مضاعف ويفوق قدرته على التحمل الجسدي مثل بعض المهام في قطاع الرعاية الصحّية – والكثير من اليد العاملة التي تقوم بمهمات روتينية تقوم على تكرار الأداء نفسه في المعامل والمصانع مثلاً… وأيضاً يشكل عاملاً إيجابياً في التعليم المُوجّه إذ يقدم تعليماً يتناسب مع كل فرد حسب مستواه من خلال محتوى علمي، موثوق، ودقيق في أغلب الأحيان.
هنا من الضروري أن يقوم الإنسان بالتدقيق، والتقييم، والتفكير، ومقارنة المعلومات المنتجة بمعلومات أخرى من مصدر آخر ومحرِّك بحث آخر للتأكد من مصداقيتها.
الذكاء الاصطناعي هو أشبه بطفل بشري، لأنه وليد العقل الإنساني ومبتكراته ومع هذا التقدّم التكنولوجي الهائل والمتسارع، يبقى السؤال: ماذا يُخبِّئ لنا المستقبل؟ هل هي مجرد مسألة وقت قبل أن تجتاح الآلة والروبوتات العالم؟ وهل سيكون الذكاء الاصطناعي هبة عظيمة للبشرية، أم سيتحوّل إلى لعنة يندم عليها الإنسان كما تحسَّر على تطوير أسلحة الدمار الشامل؟ وهل عديدة هي الاجيال التي ستمر قبل أن تتحول هذه المخاوف والنظريات إلى واقع نعيشه؟
*كاتبة وباحثة تربوية لبنانية.








